المرأة كيان رقيق شديد، مستعد للبذل والتضحية إلى أبعد حد يمكن تصوُّره.. هي نصف المجتمع، وأمٌّ للنصف الآخر.
والمرأة الفاعلة العاملة متميزة عن باقي أقرانها، فهي نافعة لمجتمعها، مساندة لزوجها، حاملة لمسؤولياتها، خبرت الناس والحياة من خلال اختلاطها بالناس ومزاولة العمل، تبني الحياة مع الزوج يداً بيد، وخطوة بخطوة، تشاركه الحلو والمر، يستفيد من نصحها ومشورتها، فهي شريكة المال والبيت والروح.
لكن هذه الميزات الموجودة عند المرأة لا ينبغي أن يقابلها ثمن باهظ، فانشغال المرأة عن البيت، وغيابها الطويل عن الأسرة يحمِّل الزوج أعباء إضافية، ويخلق فراغاً في البيت لا يمكن أن يسدَّه أحد.
بعض النساء استطاعت -مشكورة- التوفيق بين العمل والبيت، وكل من تستطيع ذلك وتحمل أعباءً إضافيَّةً تخدم بها أسرتها ومجتمعها وبلدها هي امرأة عظيمة، تستحق كلَّ الثناء والتقدير والاحترام، شريطة أن لا تؤثِّر هذه الأعباء على أسرتها، لأنَّ الأسرة في أعلى هرم الأولويات عند المرأة، وإخلالها في هذا المكان يترك ثُلماً لا يجبره غيرها من بعدها..
والمشكلة التي نراها اليوم تتمثل في أن تستغني المرأة بالنشاط والعمل، ثم تدع بيتها لتعبث فيه ريح الفساد والإهمال، فهذه تحتاج لإعادة النظر في ترتيب أوراقها.
أريدَ للمرأة أن تعمل بلا هوادة، أن تكون طرفاً في الحركة الاقتصادية الطاحنة، ربطوا وجودها بذلك، حتى تعليمها، لم يعد له قيمة بلا عملها، فلا أعلم كيف اقتنعت المرأة بأن العمل الوظيفي هو النتيجة العملية الطبيعية للتعليم، وأن انعدام العمل يعني انعدام الجدوى من التعليم وضياع سنواته الدراسية!
العلم وحده هدف يُقصد لحد ذاته، والمرأة - كما الرجل- محتاجة للارتقاء العلمي وتوسيع المدارك وتحسين المحاكمات، بغض النظر هل عملت بعد ذلك أو لم تعمل.
لا يجوز للمرأة بحالٍ أن تؤثر عملها وتنمية مهاراتها ونفسها وتحقيق الارتقاء في عملها على مصلحة أسرتها وزوجها، ولئن اجتهدت في ربيع عمرها بالتَّحصيل العلمي واكتساب المهارات الحياتية والخبرات العملية ثمَّ التفتت إلى أسرتها وزوجها وأبنائها فلا يعني ذلك إزهاقاً لِمَا حصَّلته وإتلافاً لِمَا نالته، إنَّما كان ذلك مُسهماً في زيادة وعيها وإحاطتها بأمور ما كانت تحيط بها، ونماء ثقافتها ورفع مستواها، ولتنقل بعد ذلك هذه الخبرات إلى أولادها وتفيد بها أسرتها.
وإن التفات المرأة عن بيتها وزوجها ومصلحة أسرتها لتثمير مواهبها والاستفادة من علومها هو طعنةٌ في ظهر أسرتها، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، وحكم الله في هذا سابقٌ، وإليه يرجع التَّقييم والحساب.
أعظم مهمة يمكن أن تقوم بها المرأة هي وظيفة البنت الحنون، والزوجة المصون، والأم الرؤوم، التي تبني الجيل وتعتني به، وهذا العمل العظيم لا تصلح له إلا المرأة.
إن تفرُّغ المرأة لبناء الأسرة وتربية النشء لا يعني اعتكافها في "مطبخها"، ولا عبوديتها لزوجها، ولا حبسها لخدمة أولادها...
بل يعني وضع لبنة رئيسة في بناء المجتمع ونهضة الأمة، لأن (بناء الأسرة كمؤسسة تربوية واجتماعية حيوية يعتبر مرتكزاً شرطياً أساسياً من مرتكزات النهضة الحضارية للفرد والمجتمع والأمة والإنسانية).
هناك من أراد إقناع المرأة بأن فاعليتها محصورة في العمل، وأن انعدام العمل يعني انعدام الفاعلية وضياع المسيرة العلمية واندثار الطموح! مع أن المجتمع مليء بالعاملات غير الفاعلات، والفاعلات غير العاملات، لكن هكذا أريد للمرأة أن تؤمن.. وآمنت - إلا قليلاً - ؛ حتى دخلت نساؤنا إلى الأسرة وكأنها مكان لدورها الثانوي في الحياة، لتبقى المؤسسة التي تعمل فيها موضعاً لدورها الرئيس الذي تعيش وتموت من أجله!
إن تقزيم دور المرأة في الأسرة، وتضخيم دورها خارج الأسرة شوّه خريطة تصوراتها عن الذات والحياة، فاختلطت أولوياتها، وتخبطت في حركتها، إلى أن صار عملها لسان الميزان في أسرتها، تحتكم إليه، وتتخذ قراراتها على أساسه، تتزوج وتخالع بناء عليه، وتربي وتهمِل وفق جدول عملها، حتى كثُرَت في مجتمعنا العاملات، وقلَّت - بل ندرت - الزوجة الفاعلة، والأم المدرَسة. والله المستعان.
لا ننسى أن العظماء كانت لكلٍّ منهم أمٌ بارةٌ صادقةٌ مربية وحارسة، عفيفةٌ صابرة داعمةٌ ومساندة، فصناعة العظماء تحتاج مكثاً طويلاً في البيت تأديباً وتعليماً وتوجيهاً، وهذه بعض النماذج:
-أمٌّ طَموح - هند بنت عتبة
ذكروا أن هند بنت عتبة زوجةَ أبي سفيان رضي الله عنهما كانت تمشي ذات يومٍ ومعها ولدها معاوية، فرأى بعضهم معاوية وقد بدت عليه مخايلُ النجابة، فتوسموا فيه النبوغَ وقالوا: إن عاش ابنك ساد قومه، وقد كانت هند امرأةً شريفة عظيمة الطموح فلم يعجبها ذلك، فقالت في إباء وتطلع واسع: قومه فقط...؟! عدمتُه إن لم يَسُد العرب قاطبة..!.
-الزوجة الصالحة - أسماء بنت أبي بكر:
تزوجت أسماءُ من الزبيرِ حواريِّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وشهدتْ معه اليرموكَ، تقولُ: تزوجني الزبيرُ وما لهُ في الأرضِ من مالٍ ولا مملوكٍ ولا شيءٍ، غيرُ ناصحٍ -الجمل الذي يسقى عليه الماء- وغيرُ فرسهِ، فكنتُ أعلفُ فرسهُ وأستقي الماءَ وأخرزُ غربهُ (أخيط دلوه المصنوع من الجلد) وأعجنُ، ولم أكُنْ أحسنُ الخبزَ. فكان يخبزُ جاراتٍ ليَ من الأنصارِ وكُنَّ نسوةَ صدقٍ، وكنتُ أنقلُ النوى من أرضِ الزبيرِ التي أقطعهُ رسولُ اللهُ صلى الله عليه وسلم علي رأسي وهذهِ مني على ثلثي فرسخٍ -حوالي ثلاثةِ أميال-!
ثمَّ قالتْ: فجئتُ يوماً والنوى على رأسي فلقيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومعهُ نفرٌ من الأنصار، فدعاني ثمَّ قال: «إخ إخ» -ينيخ بعيره- ليحملني خلفهُ، فاستحييتُ أن أسيرَ مع الرجالِ، وذَكَرتُ الزبيرَ وغيرتهُ وكان أغيرَ الناسِ، فعرفَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أني استحييتُ فمضى.
فجئتُ الزبيرَ فقلتُ: لقيني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعلي رأسي النوى، ومعهُ نفرٌ من أصحابهِ، فأناخَ لأركبَ فاستحييتُ منهُ وعرفتُ غيرتكَ، فقالَ: واللهِ لحَملُكِ النوى كانَ أشدَّ عليَّ من ركوبكِ معهُ.
قالتْ: حتى أرسلَ إليَّ أبو بكرٍ بعدَ ذلكَ بخادمٍ تكفيني سياسةَ الفرسِ فكأنما أعتقني. [رواه البخاري ومسلم].
احترامٌ متبادلٌ، حمايةٌ للظهرِ، رسوخٌ في الدينِ، سَعةٌ في العقلِ، إدارةٌ للعاطفةِ، حياءٌ وعلمٌ...
أسماء لا تهاب الطغاة:
تروي أسماءُ قصةَ هجرتها فتقولُ: خرجتُ وأنا متمٌ (أي قد أتممتُ مدةَ الحملِ) فأتيتُ المدينةَ فنزلتُ بقباءٍ (مكانٌ معروفٌ بالمدينةِ)، فولدتهُ بقباءٍ ثم أتيتُ بهِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فوضعتهُ في حجرهِ ثمَّ دعا بتمرةٍ فمضغها ثمَّ تفلَ في فيهِ فكانَ أولَّ شيءٍ دخلَ في جوفهِ ريقُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ حنكهُ (وضعَ في فيهِ التمرةَ ودلكَ حنكهُ بها) بتمرةٍ ثمَّ دعا لهُ وبرّكَ عليهِ (أي قال: اللهمَّ باركْ فيهِ). وكانَ أولَ مولودٍ في الإسلامِ (أي بالمدينة من المهاجرينَ). [رواه البخاري ومسلم].
وعبدُ اللهِ بنُ الزبيرَ الذي برّكَ عليهِ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ كانَ مولوداً هو الذي وقفَ للطاغيةِ الحجاجَ بنَ يوسفَ الثقفي وهو شيخٌ فاني محتمياً بالكعبةِ حتى أستشهدَ في مشهدٍ مأساويٍّ فظيعٍ! كانتْ أسماءُ فيهِ حاضرةً برأيها وشخصها، فبعدَ أنْ كبرَ ابنها عبدُ اللهِ حفيدُ أبي بكرٍ رضي الله عنهما تأزمت العلاقةُ بينهُ وبينَ الحجاجِ ومنْ كانَ يمثلهُ وتصاعدتِ الأمورُ حتى تلاقى الفريقانِ، عبدُ اللهِ بفئتهِ القليلةِ، والحجاجُ بجيشهِ، وكانَ عبدُ اللهِ عائذاً بالبيتِ الحرامِ الذي للأسف لم يراعى له حرمةً.
ولأنَّ النتيجةَ كانتْ واضحةً قبلَ بدايةِ المعركةِ فقدِ استشارَ عبدَ اللهِ أمهُ أسماءَ في موقفهِ هل يتنازلُ عنهُ أمْ يذبحُ عليهِ، فأشارتْ عليهِ بما لا تشِرْ بهِ أمٌّ غيرَ أسماءَ على ولدها، وهو أنْ يصمدَ عليهِ وإنْ كانَ في ذلكَ ذبحهُ فعظّمتْ لهُ أمرَ الحقِ في نفسهِ، ومهونةً عليهِ الباطلَ بجندهِ، لقدْ ساقتْ أسماءُ ابنها إلى الشهادةِ في موقفٍ يصعبُ علي غيرها فعلهُ. وانتهى الموقفُ كما كانُ متوقعاً وقُتلَ عبدُ اللهِ بنُ الزبير على أعتابِ بيتِ اللهِ الحرامِ.
عن أبي نوفلٍ رأيتُ عبدَ اللهِ بنَ الزبيرِ على عتبةِ المدينةِ -يقصدُ مدخلَ مدينةِ مكةَ- مصلوباً قالَ: فجعلَتْ قريشُ تمرُ عليهِ والناسُ، حتى مرَّ عليهِ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ، فوقفَ عليهِ فقالَ: (السلامُ عليكَ أبا خُبيبٍ، السلامُ عليكَ أبا خُبيبٍ، السلامُ عليكَ أبا خُبيبٍ، أمَا واللهِ لقدْ كنتُ أنهاكَ عن هذا، أمَا واللهِ لقدْ كنتُ أنهاكَ عن هذا، أمَا واللهِ لقد كنتُ أنهاكَ عن هذا، واللهِ إنْ كنت ما علمتُ صواماً قواماً وصولاً للرحمِ، أمَا والله ِأمَا واللهِ لأمَّةٌ أنتَ أشرها لأمةٌ خيرٌ) ثمَ نفذَ –مضى- عبدُ اللهِ بنُ عمرَ، فبلغَ الحجاجَ موقفُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ وقولُهُ فأرسلَ إليهِ فأُنزِلَ عن جِذعِهِ -أي جذعِ النخلةِ المصلوبِ عليهِ- فألقيَ في قبورِ اليهودِ ثمَّ أرسلَ إلى أمهِ أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ فأبتْ أن تأتيهُ فأعادَ عليها الرسولُ: لتأتيني أو لأبعثنَّ إليكِ مَنْ يسحبكِ بقرونكِ -أي بضفائركِ- فأبتْ، وقالتْ: واللهِ لا آتيكَ حتى تبعثَ إليَّ من يسحبني بقروني، قال: أروني سِبتيَّ -أي نعلي- فأخذَ نعليهِ ثمَّ انطلقَ يَتوذَّفُ -يسرع متبختراً- حتى دخلَ عليها فقالَ: كيفَ رأيتني بعدوِّ اللهِ؟ قالتْ: رأيتكَ أفسدتَ عليهِ دنياهُ، وأفسدَ عليكَ آخرتكَ، بلغني أنكَ تقولُ لهُ يا ابنَ ذاتِ النطاقينِ، أنا واللهِ ذاتُ النطاقينِ، أما أحدهما فكنتُ أرفعُ بهِ طعامَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وطعامَ أبي بكرٍ من الدوابِ، وأمَّا الآخرُ فنطاقُ المرأةِ لا تستغني عنهُ، أمَا إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حدثناً أنَّ في ثقيفٍ كذاباً ومُبيراً فأما الكذاب فرأيناه -وتعني بالكذاب المختارُ بنُ أبي عبيدٍ الثقفي فإنهُ تنبأَ وتبعهُ ناسٌ حتى أهلكه الله تعالى-، وأما الميبرُ -المهلِك، كثيرُ القتلِ- فلا أخالكَ إلا إياهُ، قال: فقامَ عنها ولم يراجعها. [رواه مسلم].
لقدْ كانتْ بحقٍ نعمَ الأمُ، ونعمَ المربيةُ، ونعمَ المدرسةُ التي علمتْ ابنها الثباتَ على الحقِ والإيمانِ، والوقوفَ على حكمِ القرآن، ثمَّ إنَّ موقفَ السيدةِ أسماءَ هذا لا يحتاجُ إلى تعليقٍ علي قدرِ ما يحتاجُ إلى تأملٍ طويلٍ عميقٍ يصوغُ نفسَ الواحدِ منا من جديدٍ!
ما هذا الصبرُ؟! ما هذه الشجاعةُ؟! وما هذه العزةُ؟! وما رباطةُ الجأشِ هذه؟! وما هذه الطاقةُ النفسيةُ الإيمانيةُ التي مكنتها من هزِّ هذا الطاغية وبعثرته؟! ما كلُ هذا؟!
-المربية العاقلة - أم سليم بنت ملحان:
أمُّ سُليمَ بنتُ مِلحانَ النجاريةُ الأنصاريةُ الخزرجيةُ، الداعيةِ المؤمنةِ، الرُّميصاء، أمُّ خادمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وصاحبهُ والمحدِّثُ عنهُ أنسُ بنُ مالكٍ، وهي أحدُ السابقينَ للإسلامِ ومن أفضلِ النساءِ في هذهِ الأمةِ.
كانتْ أمُّ سُليم ذات أنوثةٍ وجمالٍ، تزينها رزانةٌ وسدادُ رأيٍّ، وتتحلى بذكاءٍ نادرٍ وخلقٍ كريمٍ، حتى غدتْ حديثَ طيبةَ المنورةَ، يشارُ إليها بالبنانِ ويثني عليها كلُّ لسانِ.
ولهذهِ الصفاتِ العظيمةِ سارعَ ابنُ عمها مالكُ بنُ النضرِ فتزوجها، فولدتْ لهُ أنسَ بنَ مالكٍ.
وعندما علمَ زوجها بإسلامها غضبَ وثارَ عليها وأخذَ يتوعدها ويهددها ويقولُ لها بغضبٍ بالغٍ: أصَبَوتِ؟ فقالتْ بيقينٍ ثابتٍ: ما صبوتُ ولكني آمنتُ.
وجعلتْ تلقِّنُ ولدها أنساً: قلْ لا إلهَ إلا الله قلْ: أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ اللهِ ففعلَ، فغضبَ زوجها وقالَ لها: لا تُفسدي عليَّ ابني، فقالتْ لهُ: إني لا أفسدهُ بل أعلمهُ وأهذبهُ.
وعندما لم يجدْ زوجها مالكُ بنُ النضرِ سبيلاً لردها عن دينها الجديد، قررَ فراقها، فأعلمها أنهُ سيخرجُ من دارها بغيرِ عودةٍ، وقدْ كانَ ذلكَ، وبالفعلِ خرجَ فلقي بعضَ أعدائهِ فقتلوهُ، وعندما علمتْ الزوجةُ الوفيةُ بمقتلِ زوجها حزنتْ عليهِ كثيراً واحتسبتهُ، وقالتْ: (لا جرمَ، لا أفطمُ أنساً حتى يدعَ الثديَ، ولا أتزوجُ حتى يأمرني أنسُ).
وكان ما قالتْ، فكانَ أنسُ يقولُ: (جزى اللهُ أمي عني خيراً، لقدْ أحسنتْ ولايتي).
عكفتْ أمُّ سُليمَ على تربيةِ ولدها منذُ نعومةِ أظفارهِ على تعاليمِ الإسلامِ إلى أنْ أصبحَ فتى يعتمدُ عليهِ، فأخذتهُ وذهبتْ بهِ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وقالتْ: يا رسولَ اللهِ إنهُ لم يبقَ رجلٌ ولا امرأةٌ من الأنصارِ إلا وقد أتحفكَ بتحفةٍ، وإني لا أقدرُ على ما أتحفكَ بهِ إلا ابني هذا، فخذهُ فليخدمكَ ما بدا لكَ.
وكان أنسُ حينئذٍ ابنُ عشرَ سنين، فخدمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم منذُ قَدِمَ المدينةَ حتى ماتَ، فاشتُهرَ بخادمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكانَ من بركةِ خدمتهِ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ دعا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لهُ بكثرةِ المالِ والولدِ، وطولِ العمرِ ومغفرةِ الذنبِ؛ فرزقهُ اللهُ من صلبهِ بأكثرِ من مائةٍ من الأولادِ، وكان عندهُ بستانٌ يأتيهِ بالفاكهةِ مرتينِ في العامِ الواحدِ، وماتْ وهو ابن ثلاثٍ ومائةِ سنةٍ.
وما ذاكَ الفضلُ والخيرُ إلى من الأمِّ الصالحةِ التي ربتْ وعلمتْ وخططتْ لما فيهِ خيرُ ابنها:
|
الأمُّ مدرسةٌ إذ أعددتها |
|
أعددتَ شعباً طيبَ الأعراقِ |
-المرأة الطبيبة - الشفاء العدوية:
الشفاء..، ليلى بنتُ عبد الله القرشيةُ العدويةُ، المبايعةُ المهاجرةُ، امرأةٌ قرشيةٌ فاضلةٌ من بني عدي، كانت عزيزةً وسطَ قومِها، وهي ذاتُ المكانةِ والرأي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أصحابِه، ووزيرة في عهد عمر بن الخطاب، كاتبةً ومعلمةً، ترقي المرضى ويستشفون برُقياها بأمر الله، لُقِّبَتْ بالشِّفاء، فغلبَ عليها اللقب ولم تعُدْ تُعرَفُ إلا به.
أذِنَ اللهُ تعالى للشفاءِ بالهداية، وبايعَتِ الرسولَ صلى الله عليه وسلم، وهاجرَتْ إلى المدينةِ المنورةِ مع مَن هاجرَ من نساءِ المسلمين، وكانَتِ الشفاءُ تدعو إلى الإسلامِ وتنصحُ في اللهِ ولا تتوانى عن تبيانِ الأخطاء، وتمضي في الناسِ تُنيرُ القلوبَ والعقول.
ونالَتِ الشفاءُ رضي الله عنها الكثيرَ من رعايةِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم، فخصصَ لها داراً في المدينة، فنزلت فيها مع ابنها سليمانَ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يزورُها ويَقيلُ عندها في بيتها، وكانت قد اتخذَتْ له فراشاً وإزاراً ينامُ فيه، فلمْ يزَلْ ذلك عند ولدِها حتى أخذَهُ منه مروانُ بنُ الحكم.
وعندَما سألَتْه عن الرُّقى التي كانتْ ترقي بها في الجاهلية أقرَّها عليها؛ ولعلَّها كانتْ مُستمَدَّةً من صحيحِ ما بقي من الحنيفيَّةِ أو اليهوديةِ أو النصرانية، ولم تكُنْ تخالِفُ الإسلامَ وعقائدَهُ، وأعجَبَهُ صلى الله عليه وسلم منها رقيةُ النملةِ التي كانتْ ترقي بها مَن يُصابُ بلدغةِ النملة السَّامَّةِ، وكانَ مما جاء فيها: (اللهم اكشِفِ البأسَ ربَّ الناس).
فكانتِ الشفاءُ رضي الله عنها ممن اشتهر بالرقية، فقال لها صلى الله عليه وسلم: «علِّمي حفصةَ رقيةَ النملةِ كما علمتِها الكتابةَ»؛ فقد كانتِ الشفاءُ معلِّمةَ الكتابةِ في المدينة، وعلى رأس من علمَتْهمُ الكتابةَ أمُّ المؤمنين حفصةُ بنتُ عمرَ رضي الله عنهم أجمعين.
وكانتِ الشفاءُ رضي الله عنها ممَّنْ تعلَّمْنَ القراءةَ والكتابةَ في مكةَ قبلَ الإسلامِ، ولما أسلَمَتْ أخذَتْ بتعليمِ ذلك إلى نساءِ المسلمين مبتغيةً بذلك الأجرَ والثوابَ، فكانتْ بذلك أولَ معلِّمةٍ في الإسلام.
وكما كانتِ الشفاءُ محلَّ تقديرِ الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت محلَّ تقديرِ عمرَ بنِ الخطابِ في خلافتِهِ، وكان يرعاها ويفضِّلُها ويقدِّمُها في الرأي، وولَّاها شَيئاً من أمرِ السوقِ، فقد كانتِ المسؤولةَ عن ضبطِ الأسواقِ في عهدِهِ أي بمثابةِ وزيرةِ الأسواقِ، كما كان عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه يقدِّمُها في الرأيِ ويرعاها ويُفضِّلُها، وكانت هي أيضاً تُبادِلُ عمرَ الاحترامَ وترى فيه الإنسانَ المسلمَ الصادقَ والقدوةَ الحسنةَ في الإصلاحِ والتقوى والعدلِ، فمرةً رأتْ فتياناً يقصدون في المشي ويتكلمون رويداً فقالَتْ: ما هذا؟. قالوا: نُسَّاكٌ، فقالَتِ الشفاءُ رضي الله عنها: كان واللهِ عمرُ إذا تكلَّمَ أسمعَ وإذا مشى أسرَعَ وإذا ضربَ أوجَعَ.
وعاشَتِ الشفاءُ بقيَّةَ حياتها بعدَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تحظى برعايةِ الجميعِ واحترامِهِم حتى تُوُفِّيَتْ سنة 20هـ.
-المرأة المجاهدة نسيبة بنت كعب المازنية.
أمُّ عمارةَ، نسيبةُ بنتُ كعبٍ المازنيةُ الأنصاريةُ، صحابيَّة جليلة فاضلة مجاهدة من ذواتِ الأثرِ والصِّيتِ الذائعِ والخبرِ الشائعِ.
شهِدَتْ أمُّ عمارةَ ليلةَ العقبةِ؛ وبايعتْ النبيَّ بما بايعَهُ الرجالُ، أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسَهم ونساءَهم وأولادَهم، وعادَتْ إلى المدينة فَرِحةً بما أكرمَها الله به من لقاءِ النبي صلى الله عليه وسلم، عاقدةَ العزمِ على الوفاءِ بشروطِ البيعةِ، ثم مضَتِ الأيامُ سِرَاعاً، حتَّى كان يومُ معركةِ أُحُدٍ، فوَفَّتْ أمُّ عمارَةَ بيعتَها، وكان لها فيه شأنٌ، وأيُّ شأنٍ؟!
خرجَتْ أمُّ عمارةَ إلى أحُد تَحمِلُ سقاءَها لترويَ ظمَأَ المجاهدين في سبيلِ اللهِ، ومعَها لفائفُها لتضمِّدَ جراحَهُم، ولا عَجَبَ، فقد كانَ لها في المعركةِ زوجٌ وثلاثةُ أفئدةٍ هم: رسولُ الله صلى الله عيه وسلم، وولداها حبيبٌ وعبدُ الله، وذلك بالإضافةِ إلى إخوتِها من المسلمين الذائدينَ عن دينِ اللهِ المنافِحين عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
ثم كانَ ما كانَ يومَ أحُدٍ، فرأَتْ أم عمَارَةَ بعينيها كيفَ تحوَّلَ نصرُ المسلمين إلى هزيمةٍ، وكيفَ أخذَ القتلُ يشتدُّ في صفوف المسلمين فيتساقطون على أرضِ المعركةِ شهيداً إثْرَ شهيدٍ، وكيفَ زُلزِلَتِ الأقدامُ، فتفرَّقَ الرجالُ إلا عشرةً أو نحواً من عشرة.
مما جعَلَ صارخَ الكفارِ يُنادي: لقدْ قُتلَ محمدٌ.. لقد قُتل محمدٌ، عندَ ذلك أَلقَتْ أمُّ عمارةَ سِقاءَها، وانبرَتْ إلى المعركَةِ كالنمِرةِ التي قُصِدَ أشبالُها بِشَرٍّ، ولْنتْرُكْ لأمِّ عمارةَ نفسِها الحديثَ عن هذهِ اللحظاتِ الحاسماتِ، فليس كمثلِها مَن يستطيعُ تصويرَها بدقَّةٍ وصِدق.
قالتْ أمُّ عمارةَ: خرجتُ أولَ النهارِ إلى أحُدٍ ومعي سقاءٌ أسقي منهُ المجاهدين حتى انتهيتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، والدولةُ والقوةُ له ولـمَن معَه، ثم ما لبِثَ أنِ انكشَفَ المسلمون عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فما بقيَ إلا في نفَرٍ قليلٍ ما يزيدون على العَشْرَةِ، فمِلْتُ إليه أنا وابني وزوجي وأحطْنا به إحاطةَ السِّوارِ بالمعْصَم، وجعَلْنا نذودُ عنه بسائِرِ ما نملِكُه من قوَّةٍ وسلاحٍ، ورآني الرسولُ الكريمُ صلى الله عليه وسلم ولا تِرْسَ معي أقي به نفسي من ضرَباتِ المشركين، ثم أبصرَ رجلاً يفرُّ هارباً ومعه تِرْسٌ فقال له: «ألقِ ترسَكَ إلى مَن يُقاتِلُ» فألقى الرجلُ ترسَه ومضى، فأخذتُه وجعلتُ أتترَّسُ به عن الرسولِ صلى الله عليه وسلم.
وما زلْتُ أُضارِبُ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف وأرمي دونَه بالقوسِ حتى أعجَزَتْني الجراحُ، وفيما نحنُ كذلك أقبلَ ابنُ قمِئَةَ كالجملِ الهائجِ وهو يصيحُ: أينَ محمدٌ؟ دلوني على محمّدٍ، فاعترضْتُ سبيلَهُ أنا ومُصعَبُ بنُ عمير، فصرَعَ مُصعباً بسيفِه وأرداه قتيلاً، ثم ضربني ضربَةً خلَّفَتْ على عاتقي جُرحاً غائراً، فضربتُه على ذلك ضرباتٍ، ولكنَّ عدوَّ اللهِ كانت عليهِ درعان!!
تُتابعُ نسيبةُ المازنيةُ فتقول: وفيما كان ابني يناضلُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ضربَهُ أحدُ المشركين ضربةً كادَتْ تقطَعُ عضُدَه، وجعَلَ الدمُ يتفجَّرُ من جرحِهِ الغائر، فأقبلْتُ عليه، وضمدْتُ جرحَهُ سريعاً، وقلْتُ له: انهَضْ يا بُنَيَّ وجالِدِ القومَ، فالتفَتَ إليَّ الرسولُ صلواتُ الله عليه وسلامُه عليه وقال: «ومَن يُطيقُ ما تُطيقينَ يا أمَّ عَمَارةَ؟!».
ثم أقبلَ الرجلُ الذي ضربَ ابني فقالَ الرسولُ عليه الصلاةُ والسلام: «هذا ضارِبُ ابنِكِ يا أمَّ عمارةَ».
فما أسرعَ أنِ اعترضتُ سبيلَه وضربتُه على ساقهِ بالسيف؛ فسقطَ صريعاً على الأرضِ فأقبلْنا عليه نتعاورُهُ بالسيوف ونطعنُهُ بالرماحِ حتى أجهزنا عليه، فالتفَتَ إليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مبتسماً وقال: «لقد اقتصَصْتِ منه يا أمَّ عمارةَ، والحمدُ لله الذي أظفرَكِ به وأراكِ ثأرَكِ بعينِكِ».
عادتْ أمُّ عُمارةَ من أحُدٍ بجرحِها الغائِرِ، وعادَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو يقول: «ما التفتُّ يومَ أحدٍ يميناً ولا شمالاً إلا ورأيتُ أمَّ عُمارةَ تُقاتِلُ دوني».
تمرَّسَتْ أمُّ عمارةَ يومَ أحُدٍ على القتال فأتقنَتْهُ، وذاقَتْ حلاوةَ الجهادِ في سبيلِ الله؛ فما عادَتْ تُطيقُ عنه صبراً.
وقد كُتِبَ لها أن تشهَدَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أكثرَ المشاهدِ فحضرَتْ معَه الحديبيةَ وخيبرَ وعُمرةَ القضاءِ وحُنَيناً وبيعةَ الرضوان، ولكنَّ ذلك كلَّه لا يُعَدُّ شيئاً إذا قِيسَ بما كان منها يومَ معركةِ اليمامةِ على عهدِ الصديقِ رضي الله عنهُ وعنها.
أم عمارة.. أم الشهيد:
تبدأ قصةُ أمِّ عُمارةَ مع يومِ اليمامةِ منذ عهْدِ رسولِ الله صلواتُ الله وسلامُه عليه، فقد بعَثَ صلى الله عليه وسلم ابنَها حبيبَ بنَ زيدٍ برسالةٍ إلى مُسيلَمَةَ الكذابَ فغَدَرَ مسيلمةُ بحبيبٍ وقتلَهُ قِتْلَةً تقشَعِرُّ منها الجلودُ.
ذلك أنَّ مسيلمةَ قيَّدَ حبيباً ثم قال له: أتشهد أنَّ محمداً رسولُ الله؟ فقال: نعم.
فقال مسيلمةُ: أتشهدُ أني رسولُ الله؟
فقال: لا أسمعُ ما تقولُ، فقَطَعَ منه عضواً.
ثم ما زال مسيلمةُ يُعيدُ عليه السؤالَ نفسَهُ، فيَرُدُّ عليه الجوابَ نفسَه لا يزيدُ عليه ولا ينقصُ، وكان في كلِّ مرةٍ يقطعُ منه عضواً حتى فاضَتْ روحُهُ الطاهرةُ، وذلك بعد أن ذاقَ من العذابِ ما تتزلْزَلُ منه الصخورُ الصلابُ.
نَعَى الناعي حبيبَ بنَ زيدٍ إلى أمِّهِ نُسيبَةَ المازنية فما زادَتْ على أنْ قالَتْ: (مِنْ أجلِ مثلِ هذا الموقفِ أعددْتُهُ، وعند الله احتسبْتُهُ، لقد بايعَ الرسولَ صلى الله عليه وسلم ليلةَ العقبةِ صغيراً، ووفَّى له اليومَ كبيراً، ولَئِنْ مكَّنني اللهُ من مُسيلمةَ لَأجعَلَنَّ بناتِهِ يَلْطِمْنَ الخدودَ عليهِ).
ولم يُبطِئِ اليومَ الذي تمنَّتْهُ نسيبةُ كثيراً؛ حيث أذَّنَ مؤذِّنُ أبي بكرٍ رضي الله عنه في المدينة أنْ حيَّ على قتالِ المتنبِّئ الكذابِ مسيلمةَ، فمضى المسلمونَ يحثُّونَ الخُطى إلى لقائِهِ، وكان في الجيشِ أمُّ عمارةَ المجاهدةُ الباسلةُ وولدُها عبدُ الله بنُ زيدٍ.
ولما التقَى الجمعانِ وحَمِيَ وطيسُ المعركةِ كان يترصَّدُ لمسيلمةَ نفرٌ من المسلمين وعلى رأسِهِم أمّ عُمارة ووحشيُّ بنُ حرْبٍ.
لم تستطِعْ أمُّ عُمارةَ أن تصِلَ إلى مُسيلَمَةَ بعد أن قُطِعَتْ يدُها في المعركة وأثخنَتْها الجراحُ، لكنَّ وحشيَّ بنَ حربٍ وأبا دُجانةَ صاحبَ سيفِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وصَلَا إلى مسيلمةَ وضَرباهُ عن يدٍ واحدةٍ، فقد طعنَهُ وحشيُّ بالحربةِ وضربَهُ أبو دُجانَةَ بالسيفِ فخَرَّ صريعاً في طرفَةِ عينٍ.
عادتْ أمُّ عُمارةَ بعد اليمامةِ إلى المدينةِ بيدٍ واحدةٍ ومعها ابنُها الوحيدُ، وجُرِحَتْ سوى يدِها أحدَ عشرَ جُرحاً.
-زوجة الدبلوماسي - أسماء بنت عميس:
هي صاحبةِ الهجْرتين، ومصلِّيَةِ القِبلَتَين، وزوجةِ الشهيدينِ، وزوجةِ الخليفَتَين.
الصحابيةِ الجليلةِ أسماءَ بنتِ عُمَيْس الخثعمية، تُكَنَّى بأمِّ عبدِ الله، زوجةُ الصحابيِّ البطلِ جعفرِ بنِ أبي طالِبٍ رضي الله عنه صاحبِ الجناحين، ثم زوجة أبي بكر، ثم زوجة علي رضي الله عنهم.
أسلمَتْ قبلَ دخولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دارَ الأرقمِ، وكانتْ من المهاجراتِ الأُوَلِ، فهاجرَتْ مع زوجِها جعفرٍ إلى الحبشةِ، وذاقَتْ مرارةَ الغُربَةِ القاسيةِ ولوعتِها في سبيلِ اللهِ والثباتِ على الحقِّ.
ولما توجَّهَ جيشُ المسلمين إلى الشامِ كان من بين أمرائِهِ الثلاثةِ جعفرٌ زوجُ أسماءَ، وهناكَ في أرضِ المعركةِ اختارَهُ اللهُ ليفوزَ بالشهادةِ في سبيلِ اللهِ.
ولم يكنْ لهذهِ الزوجةِ المؤمنةِ إلا أن تُجَفِّفَ الدموعَ وتصبرَ وتحتَسِبَ، وانكبَّتِ الأمُّ الصالحةُ الصابرةُ على تربيةِ أطفالِها الثلاثةِ وتنشِئَتِهِم على الاقتداءِ بسيرةِ أبيهِمُ الشهيدِ الطيارِ وطبعِهِم بطابعِ الإيمان.
ولم تمضِ فترةٌ طويلةٌ حتى تقدَّمُ أبو بكرٍ رضي الله عنه خاطباً لها، وذلك بعدَ وفاةِ زوجتِهِ أمِّ رومانَ رضي الله عنها.
ولم يكنْ لأسماءَ أن ترفُضَ مثلَ الصديقِ، وهكذا انتقلَتْ إلى بيتِ الصدِّيقِ لتستَلْهِمَ منه المزيدَ من نورِ الحقِّ والإيمانِ ولتُضْفِيَ على بيتِهِ الحبَّ والوفاءَ.
ثم شَهِدَتْ أسماءُ من الأحداثِ الجِسَامِ الكثيرَ، وكان أشدَّها وفاةُ سيِّد ولَدِ آدمَ وانقطاعُ الوحيِ من السماء.
ثم شهِدَتْ زوجَها أبا بكرٍ خليفةَ المسلمين وهو يواجِهُ أعضلَ المشكلاتِ يومَئِذٍ كقتالِ المرتدينَ ومانعي الزكاةِ وبعْثِ جيشِ أسامةَ، وكيفَ وقفَ كالطَّودِ لا يتزحْزَحُ ولا يتزَعْزَعُ وكيف نصرَ اللهُ المسلمين بتلكَ المواقفِ الإيمانيةِ الجريئَةِ.
وكانتْ أسماءُ تسهَرُ على راحةِ زوجِها وتعيشُ معهُ بكلِّ مشاعِرِها حاملةً معَهُ عِبْءَ الأمةِ الكبير.
ولكنَّ ذلك لم يدُمْ طويلاً، فقد مرِضَ الخليفةُ الصديقُ واشتَدَّ عليه المرضُ، فأحسَّ بدُنُوِّ أجلِهِ، فسارعَ بوصيَّتِهِ، وكان من جملَةِ ما أوصى به أن تُغَسِّلَهُ زوجتُهُ أسماءُ بنتُ عُمَيْس رضي الله عنها.
شعَرَتْ أسماءُ بقُربِ الفاجعةِ فاسترجعَتْ واستغفرَتْ، إلى أنْ أسلَمَ الصديقُ رضي الله عنه الروحَ إلى بارِئِها، فدَمَعَتِ العينُ وحزِنَ القلبُ، ولكنَّها لم تَقُل إلا ما يرضِي الربَّ تبارك وتعالى، فاحْتسَبَتْ وصبرَتْ، ثم شرَعَتْ بالمهمَّةِ التي أوكلَها إليها زوجُها الفقيدُ حيث كانَتْ محلَّ ثقتِهِ فبدَأَتْ بتغسيلِهِ.
ولزِمَتْ أسماءُ بيتَها ترعى أولادَها من جعفرٍ ومن أبي بكر الصديق، سائلةً اللهَ أن يُصلِحَهم ويُصلِحَ بهم، ويجعلَهم للمتقين إماماً، وهذا غايةُ ما كانتْ ترجوهُ من دنياها غيرَ عالمةٍ بما يفاجِئُها من القَدَرِ المكنونِ في علْمِ الله.
ثمَّ ها هو عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه أخو جعفرٍ الطيارِ ذي الجناحينِ يتقدَّمُ لأسماءَ طالباً الزواجَ منها وفاءً لأخيهِ الحبيبِ جعفرٍ ولصاحبِهِ الصديقِ رضي الله عنهما، ورغبةً بهذهِ الصالحةِ القانتَةِ ذاتِ الأيتامِ.
وبعد تردُّدٍ من أسماءَ وتمحيصٍ للأمورِ من كلِّ جوانبها قرَّرَتِ الموافقةَ على الزواجِ من عليٍّ، لتُتيحَ له بذلك الفرصةَ لمساعدتِها في رعايةِ أولادِ أخيهِ جعفر.
وانتقلَتْ معَهُ إلى بيتِهِ بعد وفاةِ فاطمةَ الزهراءَ رضي الله عنها، فكانتْ له خيرَ الزوجةِ الصالحةِ، وكان لها خيرَ الزوجِ في حُسنِ المعاشرةِ.
واختارَ المسلمون علياً خليفةً بعد عثمانَ بنِ عفانَ رضي الله عنه، وأصبحَتْ أسماءُ للمرةِ الثانيةِ زوجاً لخليفةِ المسلمين، رابعِ الخلفاءِ الراشدينَ رضي الله عنهم أجمعين.
وكانتْ أسماءُ على مستوى المسؤوليةِ كزوجةٍ لخليفةِ المسلمينَ أمامَ الأحداثِ العظامِ، فدفَعَتْ بولدَيها عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ ومحمدِ بنِ أبي بكرٍ إلى جانبِ عليٍّ لنُصرَة الحقِّ.
ثم ما لبثَتْ طويلاً حتى فُجِعَتْ بولدِها محمدِ بنِ أبي بكرٍ، وكان أثرُ هذا المصابِ عليها عظيماً، ولكنَّ أسماءَ المؤمنةَ لا يمكنُ لها أن تخالِفَ تعاليمَ الإسلامِ، فما كانَ منها إلا أنْ تجلَّدَتْ واستعانَتْ بالصبرِ والصلاةِ على ما ألمَّ بها، وما كادَ العامُ ينتهي حتى ثَقُلَتْ وأحسَّتْ بالوهنِ يسري في جسمِها سريعاً، ثم فارقَتِ الحياةَ وبقيَتْ رمزاً على مرِّ الأيامِ بعد أن عاشَتْ حياةَ القدوةِ الصالحةِ في الحكمةِ والصبرِ على الشدائدِ.
-الخطيبة المتكلِّمة - أسماء بنت يزيد:
أسماءَ بنتِ يزيدَ بنِ السكنِ الأنصارية، خطيبةِ النساءِ في عصرِ النبوةِ التي قامَتْ بينَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أفصَحِ الخلقِ لساناً، وبين أصحابِهِ أهلِ الـمُكْنَةِ اللغويةِ والخطابيةِ حتى أقصاها، تُفصِحُ بمطالبِ النساءِ واستفساراتِهِنَّ..، من ذواتِ المنطقِ والفهمِ العقلِ والدينِ، واحدة من المبايعاتِ المجاهداتِ.
امتازَتْ برهافَةِ الحسِّ ونُبْلِ المشاعرِ ورقَّةِ العاطفةِ، وإلى جانبِ هذا كلِّهِ كانتْ كغيرِها من فتياتِ الإسلامِ اللواتي تخرَّجْنَ من مدرسةِ النبوةِ، لا تعرِفُ الخضوعَ في القولِ ولا الهبوطَ في المستوى، ولا تقبلُ الذُّلَّ والظلمَ، بل هي شجاعةٌ ثابتةٌ قدَّمَتْ لِبَناتِ جنسِها نماذجَ رائعةً في شتَّى الميادينِ..
وفدَتْ أسماءُ على رسولِ الله في السنةِ الأولى للهجرةِ وبايعتْهُ بيعةَ السَّلامِ، وكانت تسمعُ حديثَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وتسألُهُ عن دقائقِ الأشياءِ والأمورِ لِتَتَفَقَّهَ في أمورِ دينِها، وهي التي سألَتْهُ عن طريقِ تَطَهُّرِ المرأةِ من الحيضِ، وكانت شخصيتُها قويةً لا تستحي من الحقِّ ولم يمنَعْها الحياءُ أنْ تَتَفَقَّهَ، وبذلِكَ يقولُ عنها ابنُ عبدِ البرِّ: (كانَتْ من ذواتِ العقلِ والدينِ).
وكانتْ رضي الله عنها تَنوبِ عن نساءِ المسلمينَ في مخاطبةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلقُ بهنَّ، وقد أتَتْهُ صلى الله عليه وسلم ذاتَ مرَّةٍ وهو بين أصحابِه فقالَتْ له: (بأبي أنتَ وأمِّي، أنا وافِدةُ النساءِ إليكَ، واعلَمْ -نفسي لكَ الفِداءُ- أنه ما منِ امرأَةٍ كائنةٍ في شرقٍ ولا غربٍ سَمِعَتْ بمَخرجي هذا أو لم تسمَعْ إلا وهي على مثلِ رأيي.
إنَّ اللهَ بعَثَكَ إلى الرجالِ والنساءِ كافَّةً، فآمَنَّا بكَ وبإلهِكَ، وإنَّا -معشرَ النساءِ- محصوراتٌ مقصوراتٌ، قواعدُ بيوتِكم، ومفْضى شهواتِكم، وحاملاتُ أولادِكم، وإنكم -معاشِرَ الرجالِ- فُضِّلتُم علينا بالجُمَعِ والجماعاتِ، وعيادةِ المريضِ، وشهودِ الجنائزِ، والحجِّ بعد الحجِّ، وأفضلُ من ذلك الجهادُ في سبيلِ الله عز وجل، وإنَّ الرجلَ منكم إذا خرَجَ حاجَّاً أو معتمِراً أو مُرابِطاً حفِظنَا لكم أموالَكم، وغزلْنا لكم أثوابَكم، وربَّينا لكم أولادَكم، فما نشاركِكُم في الأجرِ يا رسولَ الله؟
فالتَفَتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهِهِ كلِّه، ثم قال: «هل سمِعْتُم مقالةَ امرأةٍ قط أحسنَ في مسألتِها عن أمرِ دينِها من هذِهِ؟» فقالوا: يا رسولَ الله، ما ظننَّا أن امرأةً تَهتَدي إلى مثلِ هذا!!
فالتَفَتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إليها، فقال: «انصرفي -أيتُها المرأة- وأَعْلِمِي مَن خَلْفَكِ من النساءِ أنَّ حُسْنَ تبعُّلِ إحداكُنَّ لزوجِها، وطَلَبَها مرضاتَه، واتِّباعَها موافَقَتَهُ تعدلُ ذلكَ كلَّهُ» قال: فأدبرَتِ المرأةُ وهي تهلِّلُ وتكبِّرُ استِبْشاراً).
هذا، وقد كانَتْ أسماءُ رضي اللهُ عنها تطْوي في صدرِها التطَلُّعَ إلى المشاركةِ في الجهادِ، وما إنْ أقبلَتِ السنةُ الثالثةُ للهجرةِ بعدَ وفاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حتى كانَت معركةُ اليرموكِ العصيبةِ الشديدةِ.
وفي هذِهِ المعركةِ اشتركَتِ المرأةُ المسلمةُ بنصيبٍ وافرٍ من الجهادِ كما يذكرُ الحافظُ ابنُ كثيرٍ في البدايةِ والنهايةِ وهو يتحدثُ عن المجاهدينَ المؤمنينَ الأبطالِ فقالَ: (فقاتَلُو قتالاً شديداً حتى قاتلَتِ النساءُ من ورائِهم أشدَّ القتالِ).
وقال مرةً أخرى: (واستَقْبَلَ النساءُ منِ انْهَزَمَ من الناسِ يضربْنَهم بالخشَبِ وبالحجارةِ، وجعلَتْ خولةُ بنتُ ثعلبه تقولُ: يا هارباً من نسوةٍ تقيَّاتٍ.. فعن قليلٍ ما ترى سبيَّاتٍ.. ولا حصيَّاتٍ ولا رضيَّاتٍ..).
ويقولُ أيضاً: (وقد قاتَلَ نساءُ المسلمين في هذا اليومِ وقَتَلْنَ خلقاً كثيراً من الرومِ، وكُنَّ يضرِبْنَ مَنِ انهَزَمَ من المسلمين حتى يرجِعَ إلى القِتالِ).
وفي هذِه المعركةِ العظيمةِ كانتْ أسماءُ رضي الله عنها مع الجيشِ الإسلاميِّ مع أخواتِها من المؤمناتِ خلفَ المجاهدينَ تَبذلُ جهدَها في مناولَةِ السلاحِ وسقيِ الماءِ وتضميدِ الجراحِ والشدِّ من عزائمِ الأبطالِ المسلمين.
وما إن تأزَّمَتِ المعركةُ وحميَ الوطيسُ واحمرَّتِ الحدقُ حتى نسيَتْ أسماءُ رضيَ اللهُ عنها رِقَّةَ أنوثتها مُستَحضِرَةً قوةَ إيمانِها وصبرَها وقدرتَها على الخوضِ كالرجالِ في ساحاتِ الوغى في سبيلِ اللهِ، ستجاهِدُ بحسبِ وُسعِها وطاقتِها، ولم تجِدْ أمامَها سلاحاً إلا عمودَ خيمةٍ، فحملَتْهُ وانغمَرَتْ في الصفوفِ، وأخذَتْ تضرِبُ به أعداءَ اللهِ ذاتَ اليمينِ وذاتَ الشمالِ، حتى قَتَلَتْ به تسعةً من الرومِ كما يذكرُ الإمامُ ابنُ حجَرٍ عنها إذ يقولُ: (شهِدَتِ اليرموكَ وقَتَلَتْ يومَئِذٍ تسعةً من الرومِ بعمودِ فسطاطِها، وعاشَتْ بعد ذلك دهراً).
خرَجَتْ أسماءُ رضي الله عنها من المعركةِ، وقد أثقَلَتِ الجراحُ كاهِلَها، وشاءَ اللهُ لها أن تظلَّ على قيدِ الحياةِ بعد ذلك سبعةَ عشرَ عاماً، لِتفارِقَ الدنيا في حدودِ السنةِ الثلاثين من الهجرةِ، بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالخيرِ والإيمانِ.
-الشاعرة أم الشهداء - الخنساء:
أمِّ الشهداءِ، التي لُقِّبَتْ بالخنساءِ لقِصَرِ أنفِها وارتفاعِ أرنبتِهِ، وكُنِّيَتْ بأمِّ عمرٍو، واسمُها: تماضُرُ بنتُ عمرٍو السلميةُ، رضي الله عنها وأرضاها.
كانتِ الخنساءُ ذاتَ شخصيةٍ قويةٍ، من أشهرِ شاعراتِ العربِ، حتى أجمعَ علماءُ الشعرِ أنه لم تكُنِ امرأةٌ أشعرَ منها في زمانِها، وأجْمَعَ أهلُ العلمِ بالشعرِ في وقتِها أنه لم تكُنِ امرأَةٌ قبلَها ولا بعدَها أشعرَ منها، وغلبَت الشواعِرَ من النساءِ فبرَعَتْ في الرثاءِ، كما كان لها بعضُ الخُطَبِ القصارِ، قال عنها جريرٌ: واللهِ لأنا أشعرُ الشعراءِ لولاها.
أمَّا بشارُ بنُ بُرْدٍ فقد قال: لم تَقُلِ امرأةٌ قطُّ شعراً إلا تبيَّنَ الضعفُ في شعرِها، فسألُوه وهل الخنساءُ كذلك؟ فقال: الخنساءُ فوقَ الرجالِ. وقالَ المبرِّدُ: إنَّ أعظمَ النساءِ في الشعرِ هما ليلى الأخيليةُ والخنساءُ السلميةُ.
وكان يُضْرَبُ للنابغةِ قبَّةٌ من أَدَمٍ بسوقِ عكاظٍ، فتأتيهِ الشعراءُ فتُعرَضُ عليه أشعارُها. قال: وأولُ من أنشدَهُ الأعشى ثم حسانُ بنُ ثابتٍ ثم أنشدَتْهُ الشعراءُ، ثم أنشدَتْهُ الخنساءُ بنتُ عمرٍو بنِ الشريدِ:
|
وإنَّ صخراً لتأتمُّ الهداةُ بهِ |
|
كـأنه علَمٌ في رأسِهِ نارُ |
فقال: واللهِ لولا أنَّ أبا بصيرٍ -أبو بصير الأعشى ميمونُ بنُ قيسٍ- سبقَكِ لقلتُ إنكِ أشعرُ الجنِّ والإنسِ.
هاجرَتِ الخنساءُ إلى المدينةِ، وقدِمَتْ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مع قومِها من بني سليم، وأعلنَتْ إسلامَها واعتَنَقَتْ عقيدةَ التوحيدِ، وحسُنَ إسلامُها حتى أصبحَتْ رمزاً متألِّقاً من رموزِ البسالةِ، وعزةِ النفسِ، وعنواناً للأمومةِ المسلِمَةِ المشرِّفةِ، وكان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يستنشِدُها ويعجبُهُ شعرُها، وكانتْ تُنشِدُه وهو يقول: «هيهِ يا خناسُ» وهو يومي بيدِهِ مستزيداً مسروراً.
خرجَتِ الخنساءُ رضي الله عنها في كثيرٍ من الغزواتِ، وعندما أخذَ المسلمونَ يحشدونَ جندَهم ويعدُّونَ عُدَّتَهم زحفاً إلى القادسيةِ، كانتِ الخنساءُ مع أبنائِها الأربعةِ تزحَفُ مع الزاحفينَ للقاءِ الفُرْسِ، وفي خيمةٍ من آلافِ الخيامِ جمَعَتِ الخنساءُ بَنِيها الأربعةَ لتُلقِيَ إليهم بوصيَّتِها وقالتْ لبَنِيها الأربعةِ:
(يا بَنيَّ، إنكُمْ أسلمْتُم طائعينَ وهاجرتُم مختارينَ، وواللهِ الذي لا إلهَ إلا هوَ إنكُم بنو امرأةٍ واحدةٍ ما خُنْتُ أباكم، ولا فَضَحْتُ خالَكم، ولا هَجَنْتُ حسَبَكُم، ولا غيَّرْتُ نسبَكم، وقد تعلمون ما أعدَّ اللهُ للمسلمين من الثوابِ الجزيلِ في حربِ الكافرينَ، واعلموا أنَّ الدارَ الباقيةَ خيرٌ من الدارِ الفانيةِ، يقولُ اللهُ عزَّ وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران:200].
فإذا أصبحتُم غداً إنْ شاءَ اللهُ سالمينَ فاعدُوا على قتالِ عدوِّكم مستبصرينَ، وباللهِ على أعدائِهِ مستنصرينَ، فإذا رأيتُم الحربَ قد شمَّرَتْ عن ساقِها، واضْطَرَمَتْ لَظَى على سياقِها، وجَلَّلَتْ ناراً على أوراقِها، فتَيَمَّمُوا وطيسَها، وجالِدوا رئيسَها عندَ احتدامِ حميسِها، تظفَروا بالغُنْمِ والكرامةِ في الخُلدِ والمقامةِ).
ما هذهِ الوصيةُ؟! ما هذهِ الكلماتُ؟! ما هذهِ الأمُّ؟! أهيَ منَ الإنسِ أمْ مِنَ الملائكةِ؟! أمٌّ تُحَفِّزُ أولادَها وتدفعُهم إلى الجهادِ وترغِّبُهم بالشهادةِ، وهي تعلَمُ أنهم ربما لن يعودوا، ولكنَّها تعلمُ أيضاً أنَّ الجنةَ تنتظرُهم، وتعلمُ أنَّ دينَ اللهِ أغلى وأعلى، وأثمنُ وأرفعُ، فللهِ درُّكِ يا خنساءُ.
فلمَّا أشرقَ الصبحُ واصطفَّتِ الكتائبُ وتلاقى الفريقانِ، باشرَ الأبناءُ القتالَ واحداً بعدَ واحدٍ حتى قُتِلُوا، تدفعُهُمْ كلماتُ أمِّهِمْ وتسري في عروقِهِم آثارُها، وعندما بلَغَ الخنساءَ خبرُ وفاةِ أبنائِها، قالتْ -وهي المرأةُ المحتسبةُ والصابرةُ-: (الحمدُ للهِ الذي شرَّفَني بقتْلِهِم، وأرجو مِنْ ربي أن يجمَعَني بهِم في مُسْتَقَرِّ رحمتِهِ).
- أم الإمام الأوزاعي:
لما ترجم المؤرِّخون للإمام الأوزاعي -(والإمام الأوزاعي: إمام مجتهد يجاري الأئمة الأربعة في علمه وفهمه)- قالوا عنه: الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أبو عمرو، إمام أهل الشام، وأحد الأئمة الأعلام، ولد ببعلبك، وربي يتيماً في حجر أمه، ربته أمه تربيةً تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل هذه التربية!
- ست الشام:
(فاطمة خاتون بنت الأمير نجم الدين أيوب) لقبوها بـ: (ست الشام) لمكانتها في الشام وبين أهلها، ولقبوها بـ: (عصمة الدين) لاعتصامها بدينها وخدمتها للعلم والعلماء، ولقبوها بـ: (أخت السلاطين) إذ كان لها من الملوك المحارم خمسة وثلاثون ملكاً، فكانت أخت الملوك وعمة أولادهم، إنها السيدة: فاطمة خاتون بنت الأمير نجم الدين أيوب، أخت صلاح الدين الأيوبي، أنجبت ابنا وحيداً اسمه حسام الدين، صرفت جُلَّ همها لتعليمه وتربيته؛ ربته على الديانة المتينة والأخلاق الرَّصينة وبِرِّ العباد والذود عن البلاد، فكان لها ما أرادت... فامتاز ابنها بالعلم والأدب والشجاعة والكرم بين أقرانه، فقرَّبه إليه خاله صلاح الدين، وكان أفضل أعوانه في معركة حطين سنة 583هـ، ثم أرسله عقب المعركة مع فِرقة من العسكر إلى نابلس ففتحها بالأمان، فولّاه عليها حتى وفاته بدمشق في رمضان سنة 587هـ، وفُجع صلاح الدين بوفاته، وفُجعت ست الشام بوحيدها، ودفنته في دمشق في التربة المعروفة بالتربة الحسامية نسبة إليه.
|
فلو كان النساء كمثل هذي |
|
لفُضِّلت النساء على الرجال |
خاتمة:
جميل أن نرى بناتنا ونساءنا اليوم على هذا المستوى الراقي من النماذج الفاعلة في المجتمع، غير أننا اليوم نسمع كثيراً من الأزواج يشتكون زوجاتٍ يتوجهن للعمل والتطوير والنشاطات المجتمعية بالكلِّية، ويجعلن ذلك أولوية، ويتركن خلفهن فراغاً عظيماً لا يملؤه أحد، فالأسرة مطالبة بتقدير هذا الجهد، والزوج مطالب بسد الفراغ، والحقيقة أن العمل غالباً لا يرقى إلى مستوى الضرورة، فدخل الرجل يكفي الأسرة، لكن المرأة تطمع بتحصيل المكانة الاجتماعية، والخروج من أسْر البيت، وتحصيل المال والأمان المستقبلي، ثم تغطي كل ذلك بستار السعي لبناء الأسرة والمشاركة في حمل النفقات!!
بطولة المرأة الفاعلة والعاملة تكمن في التوفيق بين المهام، وأن لا يكون بناؤها لنفسها وتحقيقها لذاتها والسعي وراء رزقها على حساب أسرتها وأهلها وزوجها وأبنائها، وإذا ما اعتادت المرأة أن تدير ظهرها للبيت لغير ضرورة هدَمَت أسرتها، وهذه أكبر خَدعة خُدِعت بها في حياتها، فمَن سيربي الأولاد حال غيابها؟! لا شك بأن الأفلام والشوارع وأصدقاء السوء سيتولون مهمة التربية عنها، ثم ستستغيث من الخلل الفكري والتربوي الذي زحف إليهم يوم كانت مشغولة عنهم.
خاطَبَتْ أستاذة جامعية غير متزوِّجة في كلية الطِّب في جامعة أوربية طالباتها قائلة: (أيتها الطالبات، أنصحُكُنّ بالزواج الآن؛ فإني خَسرتُ أغلى شيء في حياتي، خَسرتُ طفلاً يقول لي: "يا ماما").
وقديماً قيل: (وراء كلِّ رجل عظيم امرأة)، فإذا رأيتَ رجلاً ناجحاً في عمله، ناجحاً في حياته، ناجحاً في مجتمعه...، فاعلم أنَّ زوجة وراءه أو أمَّاً، أولتْه الاهتمام الواجب، فجعل يمضي في نجاحاته وتفوُّقه، والعكس بالعكس، فحين تنشغل المرأة عن أولادها سيخرج أبناؤها من عامة غثاء المجتمع، ثم عند اشتداد عودهم واستقلالهم بأنفسهم تذوق مرارة عقوقهم لها كما عقتهم بإهمالهم والالتفات عنهم.
فأعظم مهمة يمكن أن تقوم بها المرأة هي وظيفة الأم والزوجة الحانية الراعية، التي تبني الجيل وتعتني به، وتخرج للأمة أمثال الشافعي وعمر بن عبد العزيز ومالك وصلاح الدين وعائشة وأسماء.

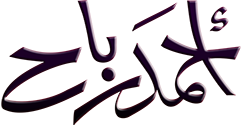
 2025-10-29 06:26:46
2025-10-29 06:26:46