بداية.. دعني أتفق معك - أخي القارئ الكريم - على قاعدة، تبيِّن أن هرب المظلوم من الظالم، ولجوءه من وطنه وأرضه إلى أرض يأمن فيها على حياته ودينه وعرضه ومشروعه، هو السلوك الطبيعي للعنصر البشري، وغير هذا السلوك استثناء يُحكَم فيه على كل حالة بحالتها، فلا داعي أن نجعل البطولة حكراً على أحد الفريقين -الخارج والثابت- دون الآخر! خاصة إن كان خروجه يحفظ له (دينه، ونفسه، وعقله، وعرضه، وماله)، وهي الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية ـ بل وكل الشرائع السماوية ـ لرعايتها والمحافظة عليها.
قد تقول لي: وهل تظن بأن خروج مَن خرَج يضمن له الحياة، وبقاءه يحتِّم عليه الموت؟
أقول لك: بالطبع لا، فلا بد من التفريق بين السلوك البشري الفطري، والقدر الإلهي القهري، وإن تفاعلنا مع الأحداث حولنا -أياً كان هذا التفاعل- لا يغني عنا من قدر الله شيئاً، فقد ضرب الله لنا مثلاً {الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا} [البقرة: 243]، (هذه عبرة وعظة يراد مغزاها، ولا تراد أحداثها وأماكنها وأزمانها، وإن تجمع هؤلاء القوم -وَهُمْ أُلُوفٌ- وخروجهم من ديارهم -حَذَرَ الْمَوْتِ- لا يكون إلا في حالة هلع وجزع، سواء كان هذا الخروج خوفاً من عدو مهاجم، أو من وباء حائم، إن هذا كله لم يغن عنهم من الموت شيئاً)([1])، وفي هذه الحالة تحديداً قالَ لَهُمُ اللَّهُ (مُوتُوا) لأنهم ظنوا بأن فرارهم هو البديل عن الرجوع إلى الله والاصطفاف في صفوف الحق.
النقطة التي أود منك أن تتفهَّمها هي أن الخروج فطرة وليس جريمة، خيار لا فرار، والمشكلة تكمن في الخروج الذي يليه الركوع والخضوع والتسليم للأمر الواقع، أما الخروج لمتابعة الطريق، للاستمرار في الإنجاز، لإنقاذ المشروع الذي هو أكبر من البقاء في بقعة جغرافية ما - سمِّها الوطن إن شئت -.. فهذا خروج تُرفع له القبَّعة! هذا خروج سماه الله نصراً حين قال: { إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ} متى يارب؟ {إِذْ} أي: حين، {أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا}.
علماً أن الذين كفروا لم يُخرجوه بشكل مباشر، بل منعوه ولحقوه وتعقبوه، إنما المعنى أن قريشاً ألجأته إلى الخروج واضطرته إليه (حين ضاقت قريش بمحمد ذرعاً، كما تضيق القوة الغاشمة دائماً بكلمة الحق، لا تملك لها دفعاً، ولا تطيق عليها صبراً، فائتمرت به، وقررت أن تتخلص منه، فأطلعه الله على ما ائتمرت، وأوحى إليه بالخروج، فخرج وحيداً إلا من صاحبه الصدّيق، لا جيش ولا عدة، وأعداؤه كثر، وقوتهم إلى قوته ظاهرة)([2])، لكنه خرج إنقاذاً لمشروعه واستمراراً في مهمته التي وجدَ فيهم لأجلها.
اللافت.. أن الله تعالى سمى الخروج نصراً كما تقدم {فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ}، وسمى العودة بعده نصراً أيضاً، فقال: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1]، هذا نصر تبِع نصراً، وليس نصراً تبع هزيمةً وقهراً، والنص القرآني خير دليل.
بالمناسبة.. كان هناك خيارات أخرى كانت متاحة للنبي الكريم، وكانت ترضي قريشاً، جمعها قول الله تعالى: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ} أي ليَحبسوك ويقيدوك([3])، {أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ} [الأنفال: 30]
الاعتقال بعد الثبات، والقتل تحت التعذيب، واللجوء الخارجي.. ثلاثة خيارات كانت تنوي قريش إيقاع أحدها بالنبي الكريم، لكن الله أوحى إلى الرسول بالخروج، لا بأس.. فلتعدَّه قريش الآن انتصاراً مرحلياً، لكن الله حَكَم بأنه نصر أبديّ!
ولك الآن.. أن تتخيل حُرقة من بقيَ بعد من غَنِم، ومَن ابتليَ بعد مَن سلِم، ولك أن تتصور شماته قريش من انهزام عدوهم، لك أن تسمع أصوات احتفالاتهم لفراره منهم، لك أن تتخيل تلك الطبول البشرية وهي تتشدق أمام الحلفاء في اجتماعاتهم، أو تتراقص على خشبة مسرح جريمتهم، لك أن تستمع إلى دوي أبواق الكفر تلعب دورها الإعلامي فتنتشر في القبائل متشفية من الهزيمة النكراء التي ألحقوها - بزعمهم - بذلك الذي أراد أن يغير الخارطة الفكرية والحياتية لأرض نشأ فيها ووطن ترعرع بين جنباته، كان قدره أن يقبَع حقبة تحت حكم صناديد الجاهلية ورؤوس الكفر!
لكن الانتقام الإلهي لم يكن منهم ببعيد، فالذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج طمأنه بهلاك من أخرجوه وتآمروا عليه قريباً، {وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا * سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا} [الإسراء: 76، 77]
نعم.. سنة الله في رسله، أن يخرجوا ضعافاً من أوطانهم، أن يتركوا الأرض لمن بيده الحكم والحديد والنار، أن يتعاملوا بوعي مع قانون القوة الأرضية، ويتطلعوا إلى بناء قوة غالبة بعد قوة الوعي تستند لقوة الحق، يعودون فيها إلى ذلك الملك الذي خافوه يوماً، وهم يتنفسون نشوة الوعد الإلهي: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ * وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ} [إبراهيم: 13-14]
نعم، التهجير محنة الرسل، فهذا إبراهيم عليه السلام يذوق كأس الإخراج: {فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ * وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ} [الصافات: 98، 99].
وهذا لوط عليه السلام يذوق الكأس نفسه، فيهدَّد بالإخراج: {قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ} [الشعراء: 167]، ثم يصدر القرار بعد التهديد: {قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} [النمل: 56 - 58]، هذا ذنب آل لوط ولوط، هذه جريمتهم، أنهم أطهار، أنهم شرفاء، أنهم قاموا في وجه الباطل يعرُّون ممارساته ويبينون خبثه وقذارته! لكنهم كانوا في مواجهة قوة قلبت الموازين، وخالفت الطبيعة السويّة بأحكام فاسدة! تلقاها جمهور من المصفقين الشاذين المنتفعين، فكانوا بمجملهم كتلة من الباطل، لم يكن الحق وقتها قادراً على دحرها في مزبلة التاريخ!
ذاق إبراهيم ولوط كأس التهديد والتهجير، وكذا شعيب -عليه السلام- أيضاً.. يذوق الكأس نفسه، {قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ} [الأعراف: 88].
حتى موسى الكليم، أحد الأنبياء أولي العزم، حين يصل الأمر إلى مؤامرة تهدد حياته ومشروعه يخرج مسرعاً، بل وخائفاً، {وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَامُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ * فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [القصص: 20، 21].
ثم يتشدق المتشدقون بعد ذلك؛ فيعيبوا على من خرج من وطنه خوفاً على نفس أو عرض أو مشروع، يعيبون عليه ما ذكره القرآن بمعرض الكرامة، ويلبسونه الهزيمة في معرض النصر، ويظنون أنه مهان وهو في ربقة الإكرام!
ألم يَمنّ الله تعالى في القرآن على من أخرجهم وسلمهم من كيد حكَّامهم؟
ألم يقل: {وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ} [البقرة: 49]؟
ألم يقلها موسى لقومه: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ} [إبراهيم: 6]؟!
ألم تكن دعوة استجابها الله لنوح عليه السلام حين قال قومه: {لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَانُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ * قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ * فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ} [الشعراء: 116 - 120]
من هنا.. فإن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لم يكن خروج إذلال أو انهزام، لم يجعله يعيد النظر في علاقته مع الله، أو في صدق دوره في رسالته، إنما وثق بمعية الله وعلم أن هذا الخروج هو خطوة على الطريق، بل وخطوة محورية سبقه بها إخوته الأنبياء، رافقتهم بها العناية السماوية كما رافقته: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا}، هذا الضعف المرحلي، هذا الخروج المرافق للتخطيط الاستراتيجي أعاد للحق هيبته ووضع مجريات الأحداث ضمن سياقها الأصلي، و{جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 40].
وللعلم، فإن النصر والتأييد حين الخروج ليس خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم وحسب، بل قاعدة تنسدح على كل من تبعَه على نهجه، أو أُخِرج من دياره ظلماً كما أخرِج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 100].
وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [النحل: 41].
سنة ماضية، ونتيجة مكررة لسبب متكرر، وهو التآمر والإخراج رداً على قناعات وحقوق وعبارات، {الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ}، كانت الجريمة مجرد قناعة، مجرد ممارسة حق، مجرد قول كان في ملفات أعدائهم مصنَّفاً على أنه جريمة، (فلو أنهم أُخْرِجوا بحقٍّ كأنْ فعلوا شيئاً يستدعي إخراجهم من ديارهم، كأنْ خدشوا الحياء، أو هددوا الأمْن، أو أجرموا، أو خرجوا على القوانين.. لكانَ إخراجهُم بحقٍّ، إنما الواقع أنهم ما فعلوا شيئاً، وليس لهم ذَنْب {إِلاَّ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا الله} [الحج: 40]، هذه المقولة اعتبرها القوم ذَنْباً وجريمة تستحق أنْ يخرجوهم بها من ديارهم)([4]).
لكن -وكما يقال-: (من مأمنه يؤتى الحذر)، فيخرج النصر من رحم هذه الهزيمة -ظاهراً-، ويبدأ التمكين من نقطة الإخراج، فالخروج -أولاً- دافع للتقوي وحافز للبذل: {وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا} [البقرة: 246]
والخروج -ثانياً- جامع لإخوة الجراح، فبهم يبدأ العمل، وتبدأ المناصرة، يبدأ التنفيذ بعد التخطيط، {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحشر: 8]
والخروج -ثالثاً- يدفع القوي في الخارج للدفاع عن الضعيف في الداخل، وبذل المستطاع له، نصرةً ودعماً ومؤازرة؛ طالما أنه عاجز عن الخروج: {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا} [النساء: 75].
ختاماً.. وبعد هذا العرض، أود أن أقول بأن الهجرة ليست ذكرى، بل منهج حياة، يدور مع الحق والباطل حيث دار، تتفق خطوطه العريضة ومضامينه الجوهرية، ويختلف في التفاصيل والأشكال والرجال، ولا شك بأن النتيجةَ -سابقاً- حتميةٌ -لاحقاً- ولو بعد حين.
([1]) في ظلال القرآن [1/ 264].
([2]) في ظلال القرآن [3/ 1656].
([3]) قال عطاء، وابن زيد: ليحبسوك، وقال السدي: الإثبات هو الحبس والوثاق. ينظر: [تفسير ابن كثير 4/ 43].
([4]) تفسير الشعراوي [16/ 9837].

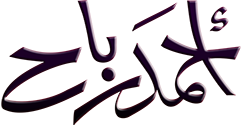
 2025-10-20 21:48:36
2025-10-20 21:48:36